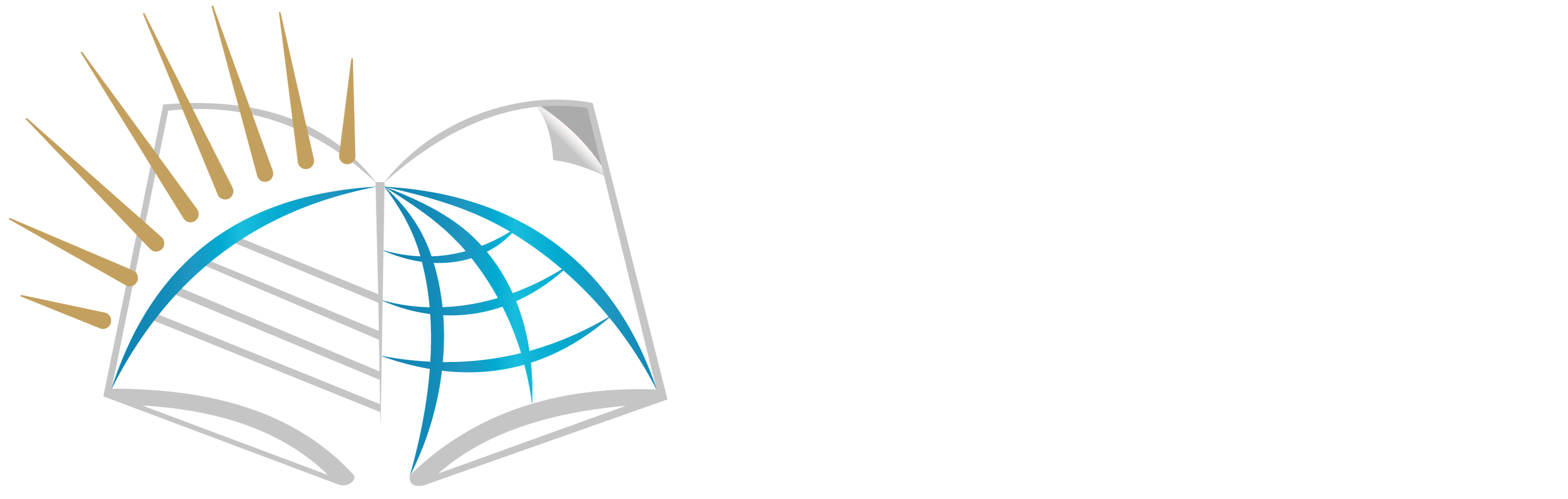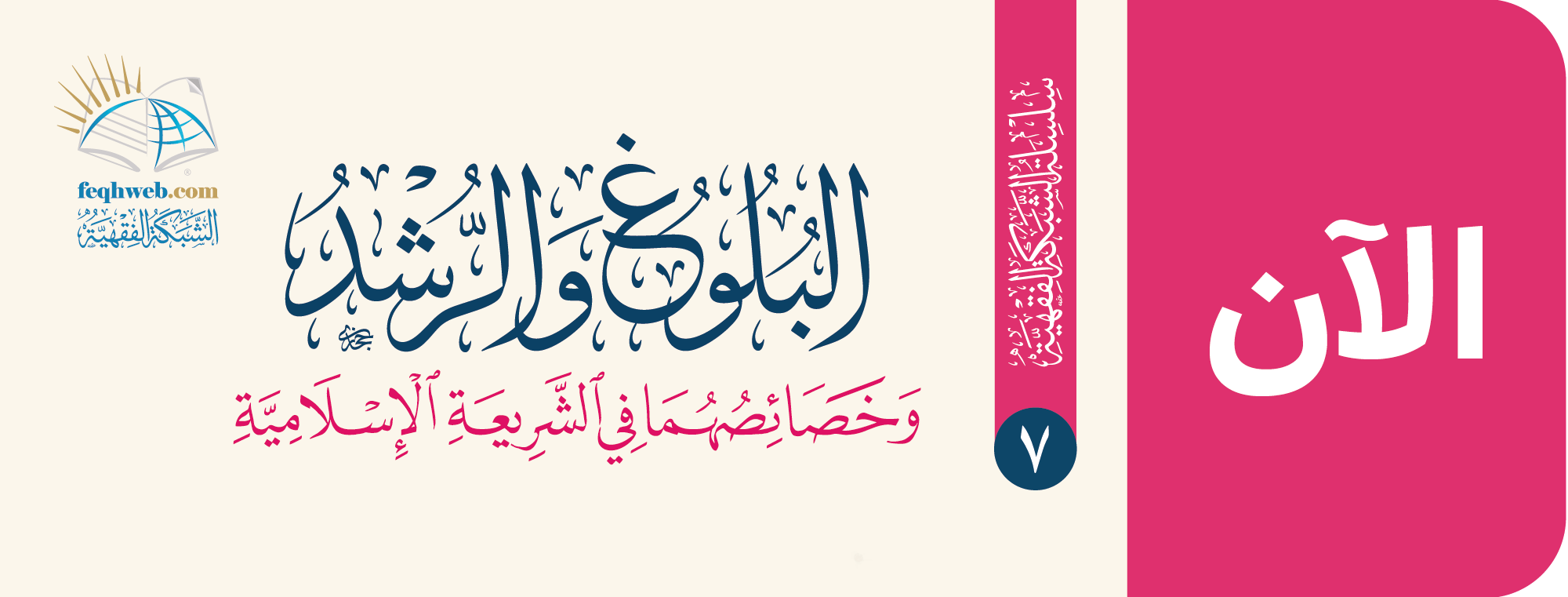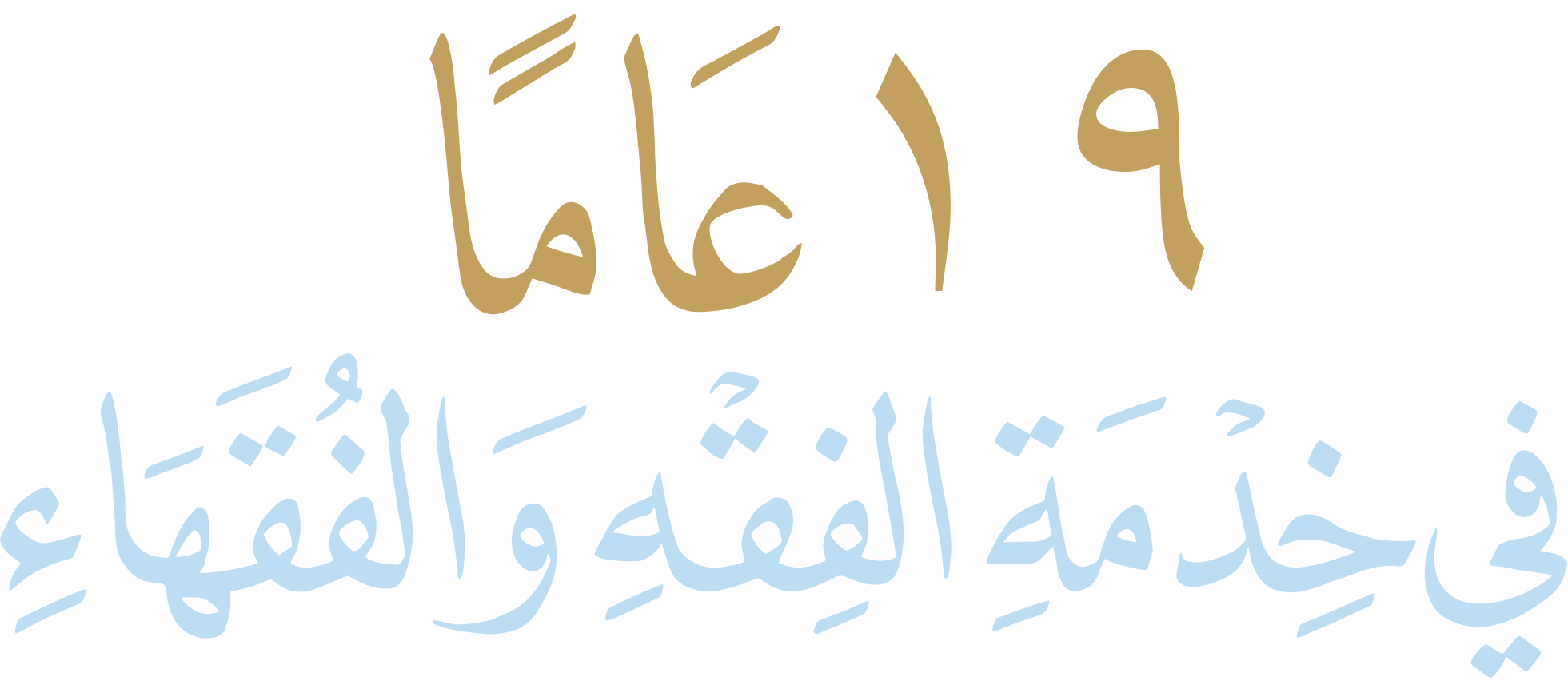- إنضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,144
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المقدمِّــة
إِنَّ الحمد لله، نحمده تعالى، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وسيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَلَّا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أَنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، اللَّهمَّ صلِّ على محمَّد النَّبيِّ الأمين، وأزواجه أُمَّهات المؤمنين، وأصحابه والتَّابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، أَمَّا بعد:فإِنَّ الله -تبارك وتعالى- لا يزال يغرس في أُمَّة الإسلام غرسًا يستعملهم بالفقه في الدِّين، وكان من أطايب هذا الغرس الفقهاء الأئمَّة المجتهدون؛ فهم في هذه الأُمَّة في موضع الصَّدارة، وهم لها يُنبوع الحكمة وأعمدة الإنارة، خصَّهم الله باستنباط الأحكام، ومزاولة الفتوى بين الأنام، فكانت أخصَّ سجيَّة فيهم «فِقْه النَّفْس»، فجاءت هذه الدِّراسة لتجلِّي مآخذ أهل العلم في معرفة مفهوم هذا المصطلح، وتشحذ الخاطر للنَّظر في المصطلحات المشابهة له؛ وتستظهر العلاقة بين مصطلح «فِقْه النَّفْس» ومصطلح «المَلَكَة الفقهيَّة»؛ استعدادًا لتحصيل النَّظريَّات بعد حصول الضَّروريَّات، لاختلاف مراتب الطَّالبين للعلم في تحصيل المَلَكَات باختلاف درجات الاستعداد؛ ولذا كان «العلم حياة النَّفس وكمالها، وصفوته أن تعرف ما عليها وما لها، وهي مَلَكَةٌ لا تحصل إِلَّا بأصولها، فوجب معرفة الأصول قبل وصولها»(1)، ومن المتقرِّر عند أهل العلم أَنَّ إدراك أوجه الشَّبه والاختلاف بين جزئيَّات المصطلحات به تتهيأ النَّفس لنيل المعارف، وتتحصَّل به الدُّربة لتحقيق مَلَكَة الاستنباط، باستخراج حقائق النُّصوص، ولحظ دقائق الوصوف، وتلك من ملاك صناعة الفقيه الحصيف.
ومن المعلوم أَنَّ مزاولة النَّظر في معاقد الأصول، سبيلٌ للتَّرقِّي في مدارج الاجتهاد والفتوى، واكتساب مَلَكَة تنمو معها هيئةٌ راسخةٌ في النَّفس للإحاطة بقواعد الشَّرع، وممارسة ما يلتحق بالقوَّة الممكِّنة للفهم بمقاصد الشَّارع، واعتبار رتب المصالح، بما يؤهِّله للنَّظر في النَّوازل، ويقتدر به على استنباط الأحكام في مستجدَّات الوقائع.
ولا طريق إلى معرفة حكم الله تعالى إِلَّا بالعلم، وما لا يتأدَّى الواجب المطلق إِلَّا به فهو واجبٌ، والطَّريق الموصلة إلى معرفة الأحكام هي أصول الفقه؛ وعليه فمعرفة أصول الفقه من الواجب المتحتِّم(2)؛ ولذا يتوجَّب على طالب العلم استدعاء التَّدرُّج في هذه المسالك، والتَّدرُّب على النَّظر وتوسيع المدارك.
وقد جاءت هذه الدِّراسة لاستقراء ما كُتب في أبواب الاجتهاد بمدوَّنات أصول الفقه عن مصطلح «فِقْه النَّفْس» كأحد الشُّروط اللَّازمة في المجتهد، إِلَّا أَنَّنا بحاجة إلى دراسة تحليليَّة لهذا المصطلح وسبر مفهومه؛ عساها أن تكون كاشفةً عن هذه الصِّفة النَّفيسة، مع فتح الطَّريق لراغبي سلوك هذا الطَّريق، والله أسأل التَّوفيق، والإعانة على المطلوب بالتَّحقيق؛ فأدلف إلى خطَّة البحث؛ لأكشف عمَّا أريد الإبانة عنه؛ فأقول:
خطَّة البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن يكون في: مقدِّمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة؛ على النَّحو الآتي:
المقدِّمة: وتتضمَّن: أهميَّة البحث، ومشكلته، وأهدافه، وتساؤلاته، وأسباب اختياره، والدِّراسات السَّابقة، وجديده، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته، وخطَّته.
التَّمهيد: تعريف فقه النَّفس لغةً واصطلاحاً، وفيه مطلبان:
المطلب الأوَّل: تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً.
المطلب الثَّاني: تعريف النَّفس لغةً واصطلاحاً.
المبحث الأوَّل: مفهوم مصطلح: «فقه النَّفْس».
المبحث الثَّاني: المصطلحات المشابهة لمصطلح: «فقه النَّفْس».
المبحث الثَّالث: العلاقة بين «فِقْه النَّفْس» و «المَلَكَة الفِقْهِيَّة».
الخاتمة: وفيها أهمُّ النَّتائج والتَّوصيات.
قائمة المراجع والمصادر.
__________________________________
(1) تيسير التَّحرير شرح كتاب التَّحرير في أصول الفقه (1/2).
(2) يُنظر: المحصول في علم أصول الفقه (ص:170)، نهاية الوصول في دراية الأصول (2/773).

لتحميل البحث:
==========================================================
==========================================================

المرفقات
التعديل الأخير: