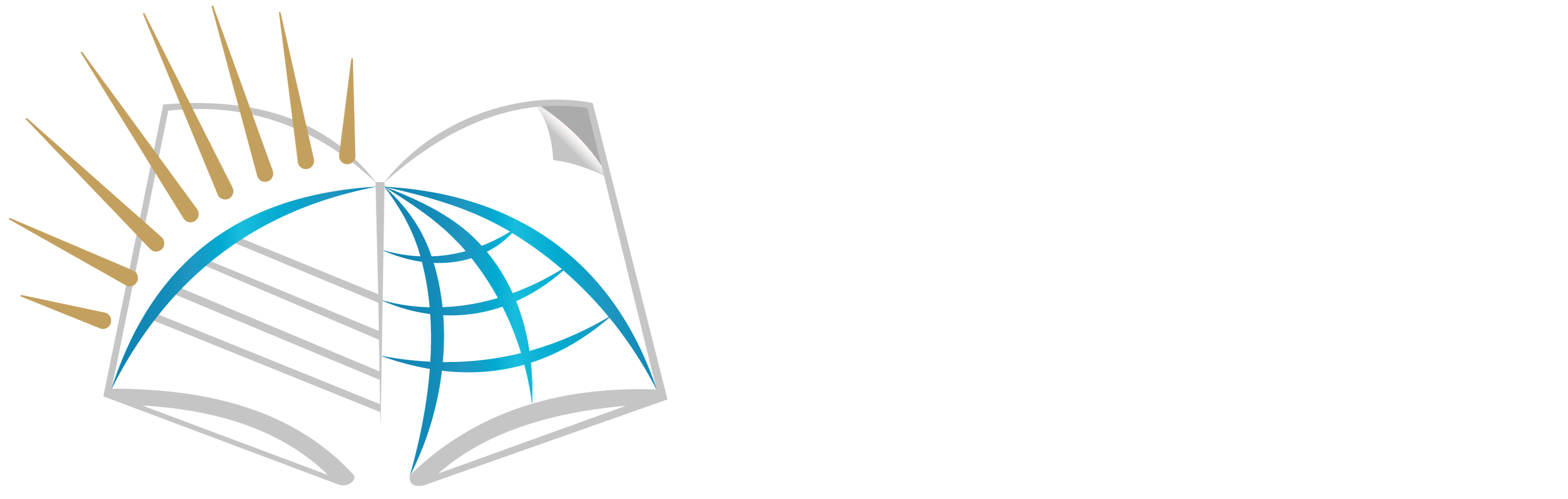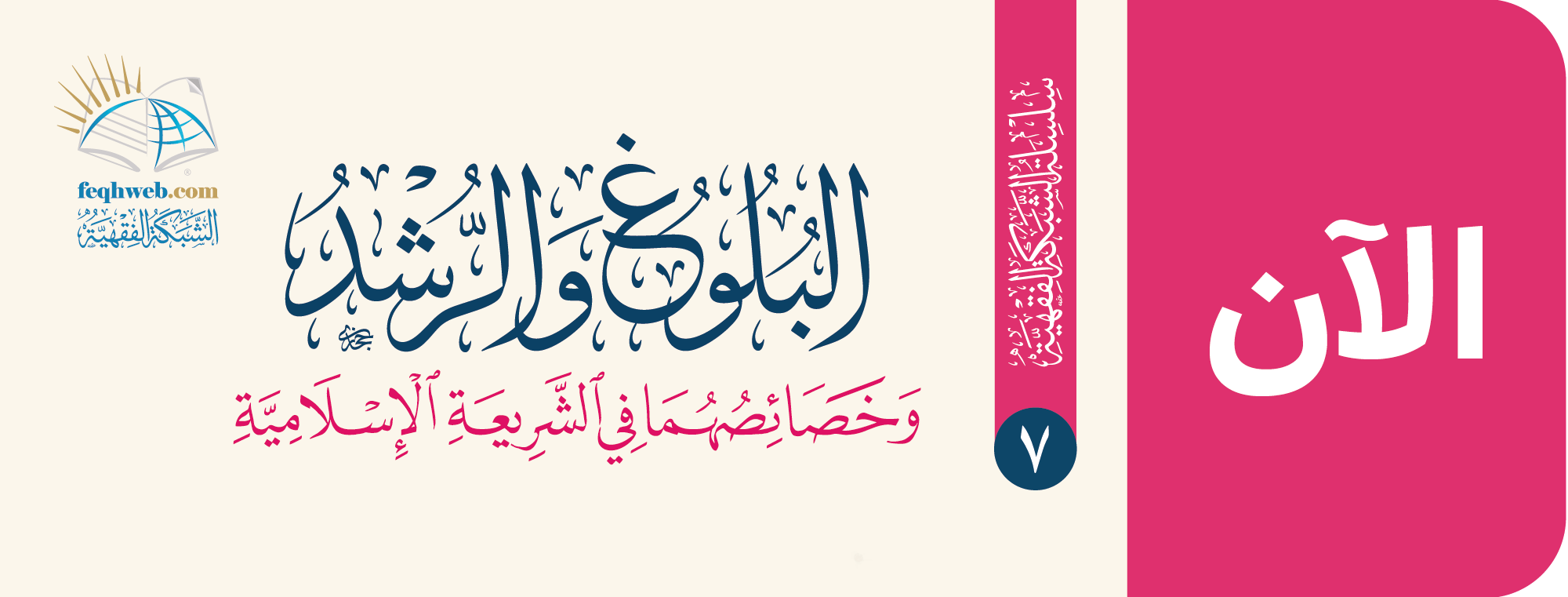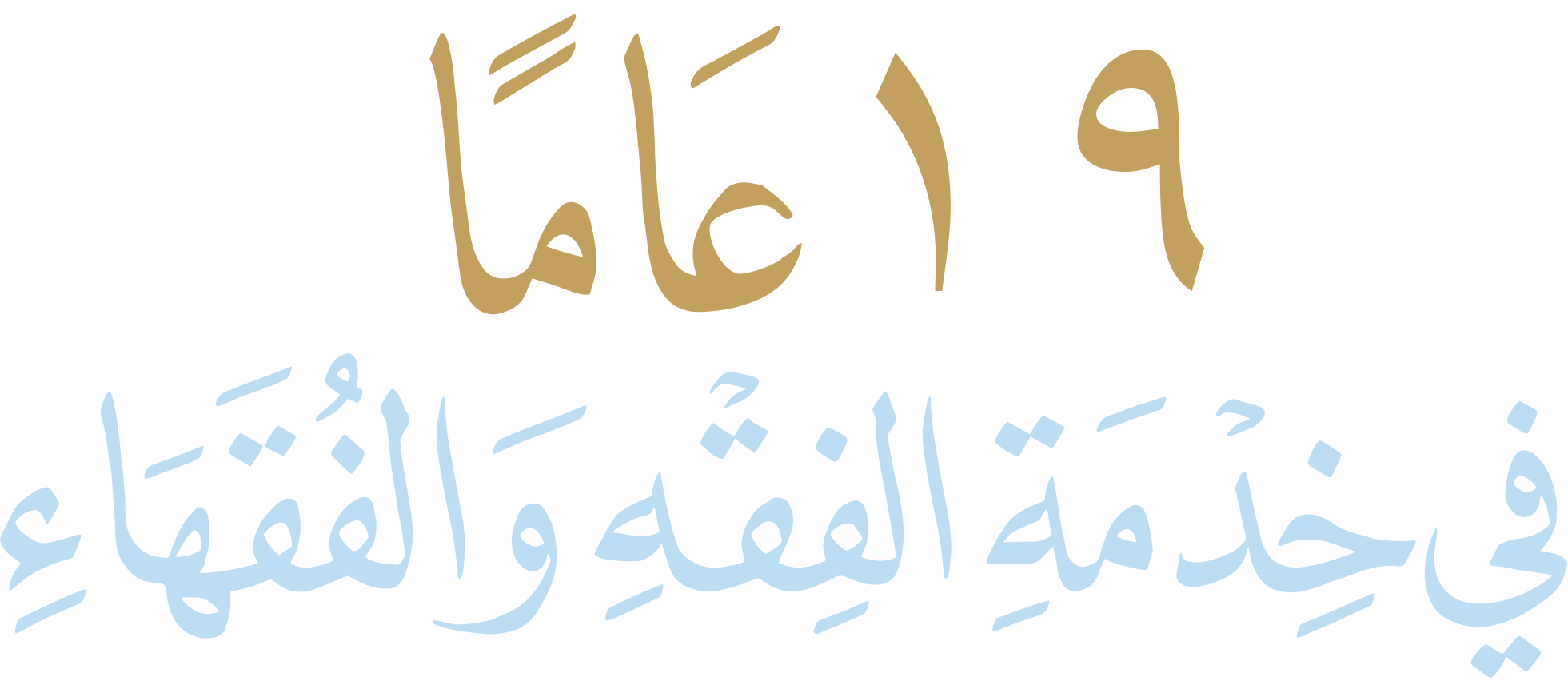عمرو بن الحسن المصري
:: نشيط ::
- إنضم
- 30 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 685
- التخصص
- طالب جامعي
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- حنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدُ لله ربّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، نبيِّنا مُحمّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ، وبعدُ..
فالرِّوايةُ بالمعنى من طُرقِ الأداء في الحديث الشريف، والأداء عند الحنفية نوعان: عزيمة، ورخصة.
فالعزيمة: أن يؤدى على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه.
والرخصة: أن يؤدى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه.
(مذاهب العلماء في الرواية بالمعنى):
وقد اختلف العلماء في رواية الحديث بالمعنى؛ فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وأئمة الحديث إلى جواز الرواية بالمعنى في الجملة بشرط أن يكون الراوي عارفًا بدِلالات الألفاظِ واختلاف مواقعها، وإن كان نقل الحديث بلفظه أَوْلَى من نقله بالمعنى.
وقال بعض أهل الحديث: لا تجوز الرواية بالمعنى مطلقًا، وهذا مذهب عبدالله ابن عمر من الصحابة ومحمد بن سيرين وجماعة من التابعين ومذهب الظاهرية وهو اختيار أبي بكر الرازي (الجصَّاص) من الحنفية - وراجع في ذلك: كشف الأسرار (3/ 55)، وتوجيه النظر (2/ 671)، فقد استوفى الآراء وأدلتها وناقشها مناقشة قيمة.
-مذهب الجمهور المجوّزين للرواية بالمعنى:
قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص(213): "إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالمًا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرًا بما يُحيل معانيها، بصيرًا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير.
فأما إذا كان عارفًا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم، ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم، ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره.
والصحيح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالمًا بما وصفناه، قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرًا ما ينقلون معنًى واحدًا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن مُعَوَّلهم كان على المعنى دون اللفظ". انتهى. وراجع: تدريب الراوي (2/ 98)، والكفاية ص(198)، وفتح المغيث (3/ 137)، ومنهج النقد ص(227).
*أدلة الجمهور:
_وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة نقلية وعقلية؛ منها:
1- ما رواه الطبراني من طريق يعقوب بن عبدالله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال: أتينا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلنا له: بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله، إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعناه. فقال: (إِذا لم تحِلّوا حَرامًا ولم تحرموا حَلالًا وأصبْتُم المعنى فَلا بَأس). رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 100)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 154): رواه الطبراني في الكبير ولم أرَ من ذكر يعقوب ولا أبيه. اهـ. ورواه أيضًا الخطيب في الكفاية ص(199)، وراجع: الإصابة (2/ 71)، (3/ 288).
2- اتّفاقُ الصحَابةِ على روايَتِهم بعض الأوَامِر والنّواهِي بألفاظِهم كأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا، وكانوا ينقلون الحديث الواحد الذي جرى في مجلس واحد في واقعة معينة بأَلفاظ مختَلِفة ولم يُنكر بعضهم على بعض فيه - كشف الأسرار (3/ 56)، والمحصول (2/ 1/ 667)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 146).
3- ما رواه ابن ماجه -في سُننه (23)-، والدارمي أن ابن مسعود كان يقول عند الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو دون ذلك أو فوق ذلك، أو قريبًا من ذلك أو شبيهًا بذلك. سُنن ابن ماجه (23) المقدمة، 3- باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى الدارمي -في سننه (1/ 95)- عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدَّث بحديثٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا أو نحوه أو شبهه أو شكله.
4- ما يُعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رَوَوْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس، وما كانوا يكررون عليها في ذلك المجلس؛ بل كما سمعوها يذكرونها، وما ذكروها إلا بعد الأعصار والسنين، وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك الألفاظ. (!!!!)
5- ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز إبدال العربية بالعجمية، فبأن يجوز إبدالها بعربية أخرى أَوْلَى، ومن أنصف علم أن التفاوت بين العربية وترجمتها بالعربية أقل مما بينها وبين العجمية - كشف الأسرار (3/ 56)، والمحصول (2/ 1/ 667)، والإحكام للآمدي (2/ 146)، ونزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني ص(94)، وشرح نزهة النظر للشيخ ابن العثيمين مع تعليقات الشيخ الألباني ص(226- 229)، ونتيجة النظر في نخبة الفكر للحافظ الشُّمُنّي القُسطَنطيني ص(173)، والباعث الحثيث للحافظ ابن كثير شرح الشيخ أحمد شاكر مع تعليقات العلامة الألباني (2/ 399- 405).
-مذهب المانعين من الرواية بالمعنى:
قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (2/ 86): "حكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يُورَدَ بنص لفظه، لا يُبَدَّل ولا يُغَيَّر إلا في حالٍ واحدة، وهي أن يكون المرء قد تثبت فيه وعرف معناه يقينًا، فيُسأل فيُفتي بمعناه وموجبه، فيقول: حكم رسول الله بكذا ونهى عن كذا... وأما من حدَّث وأَسْنَدَ القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له إلا تحري الألفاظ كما سمعها لا يُبدِّل حرفًا مكان آخر وإن كان معناهما واحدًا، ولا يقدم حرفًا ولا يؤخر آخر". انتهى.
وقال أبو بكر الرازي في الفصول في الأصول (3/ 211): "قد حكينا عن الحسن والشعبي أنهما كانا يُحدِّثان بالمعاني، وكان غيرهم -منهم ابن سيرين- يُحدِّث باللفظ. والأحوط عندنا ذكر اللفظ وسِياقه على وجهه دون الاقتصار على المعنى، سواء كان اللفظ مما يحتمل التأويل أو لا يحتمله، إلا أن يكون الراوي مثل الحسن والشعبي في إتقانهما للمعاني والعبارات التي هي وفقها غير فاضلة عنها ولا مقصرة، وهذا عندنا إنما كانا يفعلانه في اللفظ الذي يحتمل التأويل، ويكون للمعنى عبارات مختلفة فيعبران تارة بعبارة وتارة بغيرها.
فأما ما لا يحتمل التأويل من الألفاظ فإنا لا نظن بهما أنهما كانا يغيرانه إلى لفظ غيره، ومع احتماله لمعنى غير معنى لفظ الأصل، وأكثر فساد أخبار الآحاد وتناقضها واستحالتها إنما جاء من هذا الوجه؛ وذلك أنه قد كان منهم من يسمع اللفظ المحتمل للمعاني فيعبر هو بلفظ غيره، ولا يحتمل إلا معنًى واحدًا، على أنه هو المعنى عنده فيفسد.
والدليل على صحة ما ذكرنا من وجوب نقل اللفظ بعينه قوله صلى الله عليه وسلم:(نضَّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها كما سمعها، رُبَّ حامل فقهٍ لا فقه له، ورُبَّ حاملِ فقه إلى من هو أفقه فيه) -رواه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير (17/ 49) من طريق عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مروي في السنن بطرق كثيرة وألفاظ مختلفة؛ منها ما رواه أبي داود (3660)، والترمذي (2868)، وابن ماجه (230) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع)- فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل اللفظ بعينه، ليعتبره الفقهاء ويحملوه على الوجوه التي يصح حمله عليها". انتهى.
*أدلة المانعين:
1- تمسك المانعون من الرواية بالمعنى بحديث:(نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها). وأداؤه كما سمع هو أداء اللفظ المسموع.
2- وبحديث البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم وفيه:(ونبيك الذي أرسلت)فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وبرسولك الذي أرسلت)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ونبيك الذي أرسلت) -البخاري (247)، ومسلم (7057)-. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يضع لفظة رسول موضع لفظة نبي، وذلك حق لا يحيل المعنى وهو صلى الله عليه وسلم رسول ونبي.(!!!)
3- أنه ثبت بالتجربة أن المتأخر ربما استنبط من فوائد آية أو خبر ما لم ينتبه له أهل الأعصار السالفة من العلماء المحققين، فعُلم أنه لا يجب في كل ما كان من فوائد اللفظ أن يتنبه له السامع في الحال، وإن كان فقيهًا ذكيًّا نفسه، فلو جوزنا النقل بالمعنى فربما حصل التفاوت العظيم مع أن الراوي يظن أن لا تفاوت.
4- أنه لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ نفسه، كان للراوي الثاني تبديل اللفظ الذي سمعه بلفظ نفسه؛ بل هذا أَوْلَى، لأن تبديل لفظ الراوي أَوْلَى بالجواز من تبديل لفظ الشارع، وإن كان ذلك في الطبقة الثالثة والرابعة فذلك يفضي إلى سقوط الكلام الأول؛ لأن الإنسان وإن اجتهد في تطبيق الترجمة لكن لا ينفك عن تفاوت وإن قلَّ، فإن توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الأخير تفاوتًا فاحشًا، بحيث لا يبقى بين الكلام الأخير وبين الأول نوع مناسبة - المحصول للرازي (2/ 1/ 667)، وكشف الأسرار (3/ 55)، والإحكام للآمدي (2/ 148).
-تفصيل مذهب الحنفية:
رخَّص الحنفية في رواية الحديث بالمعنى إجمالًا، وعند التفصيل نجد أنهم لم يُجوِّزوا ذلك في بعض أقسام السنة، وقد قسم الحنفية السُنَّة إلى خمسة أقسام:
القسم الأول/المُحكم وهو الذي لا يشتبه معناه ولا يحتمل غير ما وضع له، وهذا يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالمًا بوجوه اللغة؛ لأن المراد به معلول الحقيقة، وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان.
القسم الثاني/الظاهر وهو ما كان يحتمل غير ما ظهر من معناه، من عام يحتمل الخصوص، أو حقيقي يحتمل المجاز، وهذا لا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع إلى العلم باللغة والعلم بفقه الشريعة؛ لأنه إذا لم يكن عالمصا بذلك لم يُؤْمَن إذا كساه عبارة أخرى، أن لا يكون تلك العبارة في احتمال الخصوص والمجاز مثل العبارة الأُوْلَى، وإن كان ذلك هو المراد به، ولعل العبارة التي يُروى بها تكون أعمّ من تلك العبارة لجهله الفرق بين العام والخاص، فإذا كان عالمًا بفقه الشريعة يقع الأمن عن هذا التقصير منه عند تغيير العبارة، فيجوز له النقل بالمعنى كما كان يفعله الحسن والنخعي والشعبي.
القسم الثالث/المُشكل والمشترك وهذان لا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلًا؛ لأن المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل، والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس، فلا يكون حجة على غيره.
القسم الرابع/المُجمل ولا يتصور فيه النقل بالمعنى؛ لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر، والمتشابه كذلك؛ لأنا ابتُلينا بالكفّ عن طلب المعنى فيه فكيف يتصور نقله بالمعنى؟! .
القسم الخامس/جوامع الكلم (التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقد جوَّز بعض الحنفية روايتها بالمعنى على الشرط المذكور في الظاهر، والصحيح عندهم أنه لا يجوز ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصًا بهذا النظم على ما رُوي أنه قال: (أوتيت جوامع الكلم) -أخرجه البخاري (7013)، ومسلم (1195)-، أي خصصت بذلك، فلا يقدر أحد بعده على ما كان هو مخصوصًا به، ولكن كلٌّ مُكلَّفٌ بما في وسعه نقل ذلك اللفظ ليكون مؤدِّيًا إلى غيره ما سمعه منه بيقين، وإذا نقله إلى عبارته لم يؤمن القصور في النظم الذي هو من جوامع الكلم، وكان هذا النوع هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثم أداها كما سمعها).
-وانظر: أصول السرخسي (1/ 356)، وكشف الأسرار (3/ 57).
ويُراجع كتاب "منهج الحنفية في نقد الحديث" للدكتور كيلاني محمد خليفة، ص(302- 307).
هذا، والله أعلم وردُّ العلم إليه أسلم.